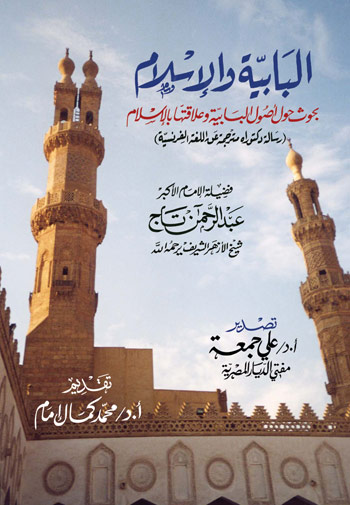تصدير لفضيلة الأستاذ الدكتور
علي جمعة محمد
مفتي الديار المصرية
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهداه وبعد،
لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون كتابَ هدايةٍ ورحمةٍ للعالمين، قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [سورة الأنعام: 155]. وهو في الوقت ذاته معيارُ ومحلُّ اختبارٍ للمكلفين، فليس كل من سمعه اهتدى به؛ بل اتبعه أناس وأعرض عنه آخرون ليَمِيزَ الله الخبيث من الطيب، فالقرآن واحد ولكن القابليات تختلف في تلقيها لأنوار ذلك الكتاب العظيم، لذا فالمشكلة في المتلقِّي وليست في القرآن: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ﴾ [سورة البقرة: 26].
وقد بيَّن لنا القرآن الكريم أن السمة الأصيلة للأديان التي أرسل الله تعالى بها الرسل هي الإيمان بالله وحده لا شريك له، مع الجزم واليقين باليوم الآخر، في إطار من التشريعات والقيم التي تحافظ على الإنسان وما حوله في الكون، وهذا ما نص عليه قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [سورة البقرة: 62].
وبهذا المعيار الرباني وذلك الميزان القرآني يمكن لكل ذي بصيرة وفطرة سليمة أن يدرك حقيقة الأقوال والادعاءات والفِرَق التي تحاول أن تتستر وراء الأديان السماوية وتدَّعي أنها خرجت من رحمها وأنها من أبناء جلدتها وتتشح بعباءتها.
وهناك أسباب عدة دعت هذه الفِرَق للبعد عن تعاليم صحيح الدين، بل وتحريف نصوصه وفهمها على غير الوجه الذي تتحمله، وبغير ما أجمعت عليه الأمة، فضلا عما استقر عليه علماؤها وارتضاه مجتهدوها. ويمكن إرجاع تلك الأسباب إلى أربع وهي: الجهل، واتباع الهوى، والغرور بالنفس، والرغبة الجارفة في السير وراء المصلحة المادية الشخصية وحدها، دون اعتبار لقيمة روحية أو مصلحة عامة.
وإن من تمام نعمة الإسلام العظمى ووجوب الحمد عليها أن الله تعالى جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل عن الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويُبَصِّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل قد هَدَوْه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين.
وقد شهد تاريخ الإسلام لأولئك الرجال الأفذاذ الذين نافحوا عنه فردُّوا كيد الكائدين، وفرقوا للناس بين المخلصين والمنافقين المدَّعين، ولم يَخْلُ زمانٌ من هؤلاء العلماء المخلصين، وكان للأزهر ورجاله قصب السبق في هذا المضمار، فما من زائغ إلا وفَوَّقوا إليه سهام الحق، وبينوا حِيَل المارقين في تلبيس الكذب بالصدق.
ومن هؤلاء الذين يفخر المسلمون بجهودهم في هذا السياق الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف الذي تناول في رسالته للدكتوراه دراسة شاملة وشافية عن إحدى الفرق التي ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر من الميلاد، وهي نحلة «البابية» التي أَطَلَّتْ برأسها على الشرق بعد ميلادها غير الشرعي في بلاد فارس، فاغتر بها بعض من لم يحيطوا بالشريعة من ناحية، ولم يدركوا الهدف الحقيقي من وراء تلك النحلة من ناحية أخرى، فسخَّر الله تعالى ذلك العالِم الجليل ليبين للناس حقيقة تلك الفرقة، وأصولها، والكتب التي ألفها متولي إثمها وهو الميرزا علي محمد الملقب بالباب، ثم ما لبث الشيخ تاج أن أتى على بنيانها الزائف بمعاول الحق ومنهج أهل الصدق حتى كشف أمرها وأزاح الستار عن أهدافها الحقيقية التي قد يجهلها بعضهم أو يغتر بمظهرها آخرون، وخلَص الشيخ إلى أنه لا علاقة بين هذه الفرقة المنحرفة والإسلام.
لقد ظهرت البابية -مثل غيرها من الفرق التي خلعت ربقة الإسلام- فادَّعت أنها الفرقة التي بيدها سعادة الناس ونجاتهم مما هم فيه تحت وطأة الظلم والاستبداد والفقر والجهل، غافلين عن طريق أهل الحق الذين يرون أن الخلاص دائمًا ليس في شخص أو بضعة أشخاص، وإنما يأتي ذلك من خلال منهج حكيم، وقيم عليا، ومبادئ سامية، ولا تتوفر كل هذه المقوِّمات إلا في الأديان السماوية، وقد بلغت ذروتها في الدين الإسلامي الحنيف بمصدريه الرئيسين: القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية الشريفة.
ولذلك كانت وظيفة العلماء المخلصين -ولا زالت- أنه إذا ظهرت فرق أو حركات ترتبط بشخص تُمجِّده وتصل به إلى أنه المخلِّص لهذا العالَم، ساعتها ينبري العلماء إلى إظهار وإشاعة القاعدة التي سُقْناها، وهي: أن العبرة بالأساس في المنهج، بقواعده ومبادئه وقِيَمه ومقاصده، وليس بالأشخاص فحسب، ممتثلين لقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [سورة الزخرف: 43].
وأخيرًا... فإن هذا الكتاب يكتسب أهمية كبيرة باعتبارات عدة، منها أهمية موضوعه؛ إذ لا يزال حفنة من الناس يعتقدون بصحة مذهب البابية ويدافعون عنه دون أن يقفوا على حقيقة تلك النحلة وأساس وجودها وغايتها، ويزداد الكتاب ثِقَلا أنه دراسة جادة في صميم عقيدة البابية ومن خلال كتبها وحياة المتصدرين فيها والمؤسسين لها، فهي دراسة في تلك العقيدة وليست حولها، والسمة الثالثة التي تزيد من قيمة هذا الكتاب أنه جاء على يد متخصص عالم جمع بين العلوم النقلية والعقلية، فضلا عن اطِّلاعه الواسع على الثقافة الغربية، فاتسمت الدراسة بالمنهجية والعمق والشمول، رحم الله الشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج، ونفع بكتابه، وجعله مشعلَ نور لكل متلمس حقٍّ يبحث عن الحقيقة ويبتغي راحة القلب، وطمأنينة النفس، وسلامة الفكر، وسعادة الدارين.
كما نتقدم بالشكر لكل من الدكتور أسامة عبد الجليل في قسم الترجمة الفرنسية بدار الإفتاء المصرية والذي بذل مجهودا كبيرا في ترجمة النص الفرنسي إلى العربية، وللدكتور فاروق طنطاوي رئيس قسم الترجمة الفرنسية بدار الإفتاء المصرية الذي قام بمراجعة الترجمة للكتاب.
والحمد لله في الأولى وفي الآخرة على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.
علي جمعة محمد
مفتي الديار المصرية
غرة رمضان سنة 1431هـ
***
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
عبد الرحمن تاج الإمام والفقيه
أ.د. محمد كمال الدين إمام
أستاذ الشريعة الإسلامية
كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية
(1)
كُتب الكثير عن الأزهر -جامعًا وجامعة- حتى الجوانب الفنية من معماره الأثري جُمعت تصاويرها وخطوطها، وأُرخ لمبدعيها ورواد فنونها، ورغم هذا التراكم المعرفي المتنوع حول سيرة الأزهر، فإن الحياة العقلية الزاخرة فيه، ومناهج علمائه في الدفاع عن الإسلام عقيدة وشريعة، وفي الذود عن لغته وآدابه، وعن تاريخه وحضارته إن هذه الحياة العقلية بكل تياراتها ومذاهبها لا تزال بعيدة عن الدرس المنهجي، ولم تتجه إليها بالقدر اللائق جهود الباحثين من أبناء الأزهر وغيرهم من أبناء الإسلام، وتأتي في مقدمة هذه الدراسات الغائبة أبحاث أبناء الأزهر المحدثين الذين صالوا وجالوا، وشرَّقوا وغرَّبوا، وبين أناملهم أقلام لا يشق لها غبار، وأفكار هي التجديد بعينه، وأسفار لم تر النور إلى يوم الناس هذا، فبعضها حبيس الأدراج عند الورثة، وبعضها الآخر حبيس لغة أجنبية نطق بها، ولم يُسْتدرج أصحابها للذوبان في ثقافة أخرى، بل حركوا مياهًا آسنة، وصححوا مفاهيم خاطئة، وردوا عن الإسلام بسلاح الحجة والحكمة ما يروجه المخالفون من أكاذيب وشبهات، وفي سياق يحاول رصد بعض هذه الفتوحات العقلية، تأتي هذه الترجمة الدقيقة لرسالة «الدكتوراه» التي تقدم بها إلى جامعة باريس الإمام الأكبر الدكتور عبد الرحمن تاج تحت عنوان (البابية والإسلام) «بحوث حول أصول البابية وعلاقتها بالإسلام»، ونشرتها عام 1942م المكتبة العامة للقانون والتشريع في العاصمة الفرنسية، كنت أعرف العلامة عبد الرحمن تاج من خلال كتابه -مع آخرين- حول تاريخ الفقه الإسلامي، وهو أول مؤلف يدرس حول تاريخ التشريع في كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية بعد تنظيمها الجديد في أوائل الثلاثينيات وهي مرحلة تطور تحمَّلها جيل من الرواد منهم الشيخ الظواهري والإمام محمد مصطفى المراغي، ومحمد عبد الله دراز، وعبد العزيز المراغي، وعبد الرحمن تاج، ومحمد الأودن، ومصطفى حبيب، وعلي الخفيف، وفرج السنهوري، وغيرهم من العلماء الذين لا تزال كتاباتهم المنهجية الرائدة مجرد ملازم قليلة النسخ وهي نادرة لا يعرفها طلاب العلم، وقد جمعت أغلبها -بعد جهد جهيد- لينفتح أمامي الأفق الواسع للثقافة الأزهرية في لحظة فارقة من تاريخها العلمي المديد.
وكنت أعرف أيضًا أن للعلامة عبد الرحمن تاج مؤلفًا في «السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» تحول به هذا الفقه من مباحث دراسية في مدرسة القضاء الشرعي وفي تخصص القضاء الشرعي إلى علم يعرض الثقافة الإسلامية الصحيحة من خلال مفهوم تصبح معه السياسة والفقه صنوانًا من أصل واحد، وأن الإسلام -بفقهه وسياسته- كفيل بتحقيق مصالح الناس في كل حال وزمان، وكان مؤلفه في القمة بين إنتاج النظراء، لمنهجيته المحكمة في ضبط المفاهيم، وبيان الفروق، وتأسيس القواعد، وتحديد المجالات، وبيان المقاصد، والتعريف بالمصادر، فجاء كتاب «السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» فريدًا في بابه مقارنًا بمن كتبوا في موضوعه قديمًا وحديثًا.
وكنت أعرف أيضًا أن للعلامة عبد الرحمن تاج كتابًا في الأحوال الشخصية، صدرت طبعته الأولى عام 1951 تحت عنوان «مذكرات ودروس في الشريعة الإسلامية» يستوعب محاضراته للسنة الثانية في كلية الحقوق جامعة إبراهيم الكبير -عين شمس حاليًا- وقد طبع الكتاب بعد اكتماله تحت عنوان «الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية».
وهو من أهم الكتب التي صدرت عن أساتذة الشريعة الإسلامية في كليات الحقوق في النصف الأول من القرن العشرين، بدءًا من مؤلفات زيد الأبياني، وأحمد أبو الفتح، وأحمد إبراهيم، ثم عبد الوهاب خلاف، والبتانوني، وعبد الرحمن تاج والذي جاء كتابه في الأحوال الشخصية يتبنى المنهج النقدي المقارن، ويدرس أنظمة الأسرة باعتبارها جزءًا من أحوال الاجتماع الإنساني، كما يقول بحق عبد الرحمن تاج، غير أنه -تبعًا لتطور العلوم والفنون، ونظرًا لتشعب الأبحاث الفقهية والقانونية وتنوعها، وتمشيًا مع مبدأ التخصص في الدراسات، ومع قوانين الاختصاص في القضاء- جَدَّ اصطلاح قانوني غير ذلك الذي كان عليه فقهاء الإسلام يخص هذه الأبواب، أي أحكام الأسرة باسم الأحوال الشخصية.
وقد ظهرت في هذا الكتاب وكتاب السياسة الشرعية الذي ظهر بعده بعامين الثقافة الواسعة للشيخ عبد الرحمن تاج، والتي تجمع بين المعرفة الإسلامية العميقة والاطلاع الدقيق على العلوم الاجتماعية الغربية وفي مقدمتها القانون، وقد يعجب القارئ المتعجل لاهتمام الشيخ بالقانون، وهو تعجب في غير محله، فالشريعة الإسلامية هي قانون المسلمين، والعلامة عبد الرحمن تاج من خريجي تخصص القضاء الشرعي ونال شهادة التخصص فيه عام 1926، وانضم منذ عام 1934 للتدريس بكلية الشريعة، وعندما اختير للتدريس بكلية الحقوق جامعة إبراهيم الكبير، عين فيها بدرجة أستاذ، وهذا أقل ما يستحق، فقد كان منذ سنوات عضوًا في جماعة كبار العلماء، وحاصلا -إضافة إلى العالمية في تخصص القضاء الشرعي- على شهادة دكتوراه الدولة في فلسفة وتاريخ الأديان من جامعة «السوربون»، وقد أقام في باريس قرابة ثمان سنوات ما بين عامي 1936- 1942، وكان أبرز أقرانه من أعضاء البعثة الأزهرية الرسمية إلى العاصمة الفرنسية. ولم يعد الشيخ عبد الرحمن تاج من باريس «متفرنسًا» كما حدث للكثيرين، بل عاد أشد اهتمامًا بثقافته الأزهرية، وأقوى إيمانًا بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين، ولديه منهجية واضحة في الدرس التشريعي وفهمه، عماده معرفة ظاهر النص في بيئته الثقافية ومعجمه العربي وقوانينه اللغوية، ومعرفة أغوار النص عن طريق التأمل في روح الشريعة، وتدبر ما تقضي به أغراضها وأسرارها، وأيضًا من خلال الاهتداء بأصول الإسلام العامة، وقواعده الكلية المحكمة، وقد دافع الشيخ عن أهمية اللغة العربية في كليات الحقوق، وكان يسعى حثيثًا إلى دعم كلية الحقوق جامعة عين شمس بمكتبة لُغوية وأدبية متكاملة، ومن أطرف ما يروى في هذا الصدد أنه كان عضوًا في لجنة شكلتها جامعة عين شمس لفحص وشراء مكتبة المفكر الكبير عبد العزيز باشا محمد وكان العضو الثاني العلامة الدكتور مهدي علام، وأثناء استعراض فهارس المكتبة لاقتسام مقتنياتها الثمينة بين كليتي الآداب والحقوق، رفض الدكتور عبد الرحمن تاج اقتراح الدكتور مهدي علام وفحواه أن القسمة الطبيعية أن تذهب كتب القانون والشريعة إلى كلية الحقوق وكتب الآداب واللغة إلى كلية الآداب، ولكن الدكتور عبد الرحمن تاج أصر على أن تذهب كتب اللغة وأمهات كتب الأدب إلى كلية الحقوق، وحجته في ذلك أن العمل والدراسة في هذه الكلية يحتاجان إلى معاجم اللغة وأمهات كتب الفنون الأدبية، وهو في ذلك على حق؛ لأن اللغة هي وعاء الأمر والنهي لكل تشريع، وبغيرها لا يحسن فهم ولا يصيب قضاء.
(2)
كان مولده في أواخر القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1896، حيث استقبلت مدينة أسيوط -بتاريخها ومكوناتها- طفلًا قدر له بعد ثلاثين عاما أن يمتلك ناصية الثقافة في العقيدة والشريعة واللغة، وأن يحصل على العالمية في عام 1923 ثم استكمل طموحاته بالحصول على شهادة التخصص في القضاء الشرعي عام 1926 وهي في حينها تعادل درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية، ليعود إلى مسقط رأسه شيخًا معممًا يحمل في داخله إحساسًا بجسامة المسؤولية، وثقل الأمانة، فقد عاد معلمًا في ذات المعهد الديني الذي شهد أولى خطواته على طريق التعلم، وقبل أن تحمله الأيام إلى الإسكندرية، وبالذات إلى معهدها الديني المرموق بأعلامه ومنهجه التعليمي الصارم، والمنافسة القائمة بين نوابغه الذين انضم إليهم منذ عام 1910 ملحقًا بالسنة الثانية الابتدائية، وعاش فيه حتى أكمل دراسته الثانوية، وفرض عليه الرحيل إلى القاهرة طالبًا لفت إليه الأنظار في رحاب الأزهر الشريف.
لم تكن الإسكندرية في أوائل القرن الماضي مدينة عادية، ولا كان معهدها الديني كغيره من المعاهد في شمال مصر وجنوبها.
أما المدينة، فقد ازدحمت بالوافدين من كل صوب، يحملون معهم بضاعتهم الفكرية والأدبية ومذاهبهم وأديانهم كما يحملون سلعهم التجارية، وفي الإسكندرية التي عاش فيها الشيخ عبد الرحمن تاج أقليات من كل لون، ومهاجرون من عوالم متعددة، وصحف متصارعة، ورجال دين ورجال دنيا ملؤوا الأسواق وشغلوا الناس، ولا أظن الذاكرة الواعية «للمتلقي» عبد الرحمن تاج خلت من تأمل هذا المشهد المتنوع دينيًّا وفكريًّا وسياسيًّا، بل أظنه بقي في داخله زادًا ساهم في تكوين أصالته الفكرية، وانفتاحه الثقافي، وقوة حجاجه التي جعلته متميزًا بين أهله وفي سنوات اغترابه.
أما المعهد الديني بالإسكندرية، فكان مشروعًا إصلاحيًّا بكل معنى الكلمة، وكثير من أبنائه أُلْقِيَت إليهم فيما بعد مقاليد القيادة الفكرية في الأزهر الشريف، بل إن بعض أبنائه احتلوا مقدمة الصفوف بين التيارات العاملة في المجال الديني على اختلاف اتجاهاتها وتباين غاياتها. وأغلب الظن أن معهد الإسكندرية الديني كان من أهم روافد التكوين العلمي لعبد الرحمن تاج، والذي أهَّله فيما بعد لأن يكون من أوائل من اختيروا للتدريس في الجامعة الأزهرية الجديدة، ولم يكن ذلك بالأمر الغريب فقد كان عبد الرحمن تاج هو الأول على زملائه في جميع مراحل الدراسة، وكان محل ثقة أساتذته، وفي أواخر الأسبوع كان يلقي الدروس نيابة عنهم، وفي هذا المعهد بدأت إرهاصات ملكته النقدية، وقدرته على الحجاج والمناقشة، وكان يدخل قاعة الدرس وقد قرأ ما سيتلى عليه، واستوعب منه ما يتوافق مع عقله المتوثب، فكان يسأل عن علم، ويستقبل الإجابة استقبال الظامئ إلى الري، فكان أسبق من سنه، وشهد له أساتذته بالنبوغ والتفوق.
وعندما دخل إلى رحاب الجامعة مدرسًا كان من أوائل من بدؤوا التأليف فيها، وفي علمين كانا بحاجة إلى تأسيس وتجديد وهما الفقه المقارن وتاريخ الفقه، ولولا اختياره عضوًا في بعثة الأزهر الشريف العلمية عام 1936 والتي وجهتها «السوربون»، لولا ذلك لرأينا إنتاجًا رسم الشيخ عبد الرحمن تاج خارطته العلمية وبدأت ثمارها الأولى تتجلى دروسًا يجتمع لسماعها طلاب كليات الجامعة الأزهرية الثلاث، وليس طلاب كلية الشريعة فحسب.
وعاد الشيخ بعد ثمان سنوات من باريس وكانت الحرب العالمية الثانية تمثل أوج الصراع المحتدم بين القوى الغربية المتناحرة، عاد الشيخ رغم مخاطر العودة، فقد جعله إيمانه مطمئنًّا على نفسه وعلى أسرته، وعاد الشيخ إلى أرض الكنانة في ظروف تاريخية حرجة، والإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي يقود سفينة الأزهر بذكاء وألمعية بين أمواج متلاطمة، ورياح هائجة، ومنذ اللحظة الأولى عاد الشيخ إلى موقعه في كلية الشريعة، وإلى تخصصه في القضاء الشرعي، ولكنه إضافة إلى ذلك استأنف عمله في لجنة الفتوى ممثلا مذهبه الحنفي، واحتل موقعه في جماعة كبار العلماء، واستفاد الأزهر والدولة بعلمه الغزير وتجاربه الواسعة، وفي عام 1950 اختير للعمل أستاذًا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة إبراهيم باشا الكبير، وعندما جاءت ثورة 23 يوليو اختارته عضوًا في لجنة صياغة الدستور المصري الجديد، وفي عام 1954 صدر القرار الجمهوري بتعيينه شيخًا للأزهر، فدخل المشيخة ومعه مشروعه الإصلاحي، وقد تمثل في جانبين:
الجانب الأول: إجرائي، حاول فيه التأسيس لاستقلالية الأزهر والحفاظ على هيبته، وقد ظهر ذلك في صدامه مع أكثر من مستوى رفيع من أبناء ثورة يوليو من أمثال جمال سالم وعلي صبري.
الجانب الثاني: موضوعي، حيث عمل الإمام الأكبر عبد الرحمن تاج -متأثرًا بثقافتيه الإسلامية والغربية- على إحداث نهضة في الأزهر، بدأت بإصلاح الهيكل التنظيمي والإداري، ثم بإدخال اللغات الأجنبية في المقررات الدراسية الأزهرية، والاهتمام بالوافدين من أبناء العالم الإسلامي، وفي عهده أنشئت مدينة البعوث الإسلامية.
ويبدو أن هذا المشروع الإصلاحي للشيخ عبد الرحمن تاج بجانبيه لم يكن محل ترحيب من بعض قادة ثورة يوليو، إلا أنه لم يكن سهلا إزاحة الشيخ عن منصبه، فمنصب شيخ الأزهر له صداه في العالم الإسلامي، إضافة إلى كون الشيخ عبد الرحمن تاج من أسيوط في صعيد مصر وهي بلد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وأيًّا ما كان الأمر فقد استطاع خصوم عبد الرحمن تاج إبعاده عن الأزهر بعد سنوات أربع وفي منصب يبدو رفيعًا، ولكنه دون أهمية الأزهر في تأثيره ودوره، فصدر عام 1958 قرار عُين فيه شيخ الأزهر وزيرًا في اتحاد الدول العربية الذي ضم سوريا واليمن ومصر، وفي عام 1963 اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية حتى وفاته عام 1966.
وما بين استقباله في مجمع اللغة العربية ورحيله ثلاث سنوات حافلة بالإنتاج المجمعي الدقيق، وبالاحتفاء الحقيقي بعلم الشيخ وأدبه.
عَبَّرَ عن ذلك الشيخ علي عبد الرازق في حفل استقبال الشيخ بمجمع اللغة العربية فقال: «إن فضيلة الأستاذ -يقصد عبد الرحمن تاج- قد نال من الدرجات العلمية ما رفعه إلى مستوى لا مطمع لكثير من الناس أن يصلوا إليه، ولكنه هو نفسه استطاع أن يبلغه، وأن يبلغ من الفضل مقامًا فوق ذلك مظهرًا، وأرفع قدرًا، وأكبر مقامًا، مقامًا تتهادى دونه درجات العلماء، ومقامات الخبراء، وتتخاذل دونه الألقاب، وترتد المطامع عنده وهي كليلة حسرى».
وعَبَّر عن ذلك في يوم رحيله العلامة علي الخفيف بقوله: «كان فقيدنا الأستاذ الإمام -رضي الله عنه- من أولئك الذين حيوا بعلمهم، وسموا بأخلاقهم، وعملوا بعلمهم، فكتبوا لأنفسهم الخلود بما تركوا من علم يُتَدارس، ومعرفة تُتَوارث، وأفكار تُهدى، فكان فيه الأسوة الحسنة لمن أراد لنفسه سموًّا لمنزلة عليا، ولذكره بقاء، ولحياته خلودًا. كان رحمه الله واسع الاطلاع، كامل الثقافة، وافر المعرفة، خلَّف وراءه من الطلاب والأتباع من هيأ لهم وسائل نجاحهم، وقرب إليهم موارد خلاصهم، وأتاح لهم فرص تحصيل العلوم وهضمها ما ينمي مداركهم، ويزيد معارفهم. لقد فقدنا بفقده -رضي الله عنه- الشيخ الجليل والإمام العظيم، والنابغة في الفقه والتفسير، والضليع في العربية وعلومها، فكان الخطب فيه جللا، والخسارة فادحة لا للأزهر وحده، ولا لمجمع اللغة العربية فحسب، بل للأمة الإسلامية جمعاء.
إذ كان -رضي الله عنه- أمة وحده عالمًا متبحرًا، باحثًا مدققًا، وأستاذًا متمكنًا، مؤمنًا برسالته، مخلصًا لدعوته، خلف لنا ثروة علمية قيمة، فيما ترك من كتب ورسائل، وفيما نشر من مسائل، وفيما زود به مجمع اللغة العربية من بحوث تضمنت أفكارًا مشرقة هادية، وآراء سديدة قيمة، تنم عن علم زاخر، ونظر دقيق، وبحث فاحص، مع سلامة في الحكم، واستقامة في النظر، وتدقيق في اختيار أحسن الآراء.
ولذا فإنه ترك بوفاته -رحمه الله- فراغًا لا يُملأ، وأسى لا يُنسى، كان -رحمه الله- سمحًا في أخلاقه، متميزًا في أدبه متفوقًا في علمه، لم ينل من نفسه هوى المنصب، وما لمشيخة الأزهر من جاه، وما تحظى به من مكانة في النفوس، وسلطان في القلوب، وما عزت به من هيبة روحية ومكانة دينية، ولم يكن ذلك يشغله عن أن يكون باحثًا مدققًا نافذًا مفكرًا، لا يرضى إلا بالحقائق واضحة جلية».
لقد كان الشيخ بحق -كما وصفه الدكتور إبراهيم بيومي مدكور- من ثمار السلف الصالح، الذين امتلأت نفوسهم بالإيمان الصادق، واتسعت صدورهم لكل جديد نافع.
وفي عبارة موجزة معبرة قال عنه العلامة مهدي علام «لقد كان أخفتنا صوتًا، وأعلانا حجةً».
(3)
عاش الإمام عبد الرحمن تاج في قلب الحركة الإصلاحية الحديثة في مصر، وساهم في مجالاتها المتعددة بالكلمة الرصينة والموقف الشجاع، كان من أوائل من قادوا معركة تجديد الأزهر جامعًا وجامعة في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولم يتردد عن معالجة أدق المشاكل في علوم الفقه واللغة، وكان له نصيب وافر في تحديد العلاقة بين الدين والدولة، وبين الشريعة والمجتمع.
في العلاقة بين الدين والدولة رد -في أكثر من مقال- على دعاة الفصل بينهما، وكانت له في لجنة إعداد الدستور بعد ثورة 23 يوليو آراء ومناقشات، تكشف عن فهم عميق لروح الإسلام، وفي حواراته التي تستوعبها المحاضر الرسمية حديث شامل، ورؤى عميقة في مواجهة ما قدمه مفكرون كبار من أمثال طه حسين، وعلي عبد الرازق، وعبد الرحمن بدوي، ويحسم ضوابط العلاقة بين الدين والدولة بعبارة واضحة وجملة القول عنده «أنه لا يصح في تصرف من التصرفات أو حكم من الأحكام التي تسن لتحقيق مصلحة عامة أن يقال إنه مناقض للشريعة بناء على ما يُرى فيه من مخالفة ظاهرية لدليل من الأدلة، بل يجب تَفَهُّم الأدلة، وتَفَهُّم روحها، والكشف عن مقاصدها وأسرار التشريع فيها، والتفرقة بين ما ورد على سبب خاص وما هو من التشريع العام الذي لا يختلف ولا يتبدل، فإن مخالفة النوع الثاني هي الضارة المانعة من دخول أحكام السياسة في محيط شريعة الإسلام».
أما العلاقة بين الشريعة والمجتمع فهو يقيمها على المساواة ويقول: «أما حديث: «الناس سواسية»، فإن معناه أنهم سواسية في الحقوق والواجبات وفي أمور الدين وفي كل ما يرجع إلى النظام العام، فهم يتفاضلون بالتقوى ومراعاة هذه الحقوق والواجبات، أما فيما وراء هذا فلا شك أن الناس متفاوتون في المنازل والدرجات.
واستمع إلى رؤيته الاجتماعية الثاقبة وهو يقرر حق المرأة في الطلاق، يقول الإمام عبد الرحمن تاج: «إن الشريعة قد راعت في مواطن كثيرة -تحقيقًا لمعنى الهناءة والاستقرار للحياة الزوجية- توفيرَ أسباب الهناءة وموجبات هذا الاستقرار، فلم تهدر رأي المرأة وحقها في الطلاق، بل جعلت لها كامل الحق في المطالبة به، وأوجبت على القاضي أن يجيبها إلى طلبها، ويفرق بينها وبين زوجها، متى أبدت من الأسباب ما تقرره العدالة وتؤيده الشريعة التي شددت في وجوب رعاية الزوجة والمحافظة على أسباب راحتها وسعادتها، وأوردت في ذلك من التعاليم أكثر مما أوردته لأجل الرجل؛ نظرًا لأنها صاحبة المدرسة الأولى التي إليها تربية النشء وإصلاحه وتهذيبه، وعلى جهودها الصالحة النافعة تقوم سعادة الأسر وهناءة الأمة.
هذا وإذا كانت الشريعة قد أعطت المرأة حق الالتجاء إلى القضاء ليفرق بينها وبين زوجها في الحالات التي لا تستقيم فيها أمور الزوجية فذلك لا ينبغي أن يكون مبررًا للنزعة التي ينادي أصحابها بأن أمر الزواج كله يجب أن يكون وقفًا على القضاء، فلا يملك الرجل أن يطلق امرأته فيما بينه وبينها، فإن هذه النزعة خطرة ليست في صالح الرجل والمرأة، وليست في مصلحة الأسرة والأمة، وهي عسيرة التحقيق، ومن شأنها أن تنشر خبايا البيوت، وتفضح أسرار الأسر، وهل كل أسباب النفور بين الزوجين يمكن الإفضاء بها أمام القضاء؟
وهل مما يليق في قوانين الآداب العامة -إذا كان سبب الفرقة مما يرجع إلى الأخلاق والسلوك أو غيرها مما نهت الشريعة عن فضح أمره، وأمرت بالتصرف فيه على ما يحقق المصلحة ويراعي الآداب- أن يسجل ذلك كله في سجلات القضاء؟
لا... إنه يجب أن نراعي في الشؤون العامة ألا نخضعها للأهواء والنزعات الفردية، وألا نُحَكِّم فيها الرغبات الجانحة والميول المتنقلة غير المستقرة، ونظام البيوت والأسر لا ينبغي أن يكون في كل وقت تبعًا لتلك الرغبات والأهواء ولو كانت على خلاف شرائع السماء».
هذه لمحات من فقه الإمام تاج، وله من الاجتهادات ما قد يتجاوز المذاهب كلها، ومثال ذلك شرحه الأخلاقي -وليس الفقهي- لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
(4)
من اللافت للنظر أن المشروع الإصلاحي للشيخ عبد الرحمن تاج لم تتحدد معالمه، ولم تظهر تآليفه إلا بعد أن جمع بين ثقافتين: إسلامية أصيلة، وغربية تعامل معها الشيخ بعقل مفتوح ومنهجية نقدية صارمة. وإذا تجاوزنا كتاب «تاريخ التشريع الإسلامي» الذي أسهم مع بعض زملائه في إعداد وكتابة مادته، فإن الكتاب الأول للشيخ عبد الرحمن تاج هو كتاب «البابية والإسلام» والذي صدر عام 1942 عن المكتبة العامة للقانون والتشريع بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو أطروحة تقدم بها الإمام عبد الرحمن تاج إلى جامعة السوربون للحصول على دكتوراه الدولة في الآداب وفي تخصص الفلسفة وتاريخ الأديان، وحصل على الدرجة العلمية بأعلى تقدير، وحاولت البابية وأعوانها إخفاء هذا العمل الذي ظل رهين المحبسين:
الأول: لغة فرنسية جعلته غائبًا عن جمهوره وبعيدًا عن أهله وذويه.
والثاني: موقف عدائي أراد حجب الكتاب عن أعين القراء لأن البابية في خطر ما بقي الكتاب متداولا ينفي مزاعم البابية، ويكشف زيف أفكارها وخطورة دعوتها، وقد استطاع الشيخ -بمهارة العالم الفذ الذي يمتلك كل أدواته العلمية- أن يقدم البابية باعتبارها فرقةً ضالةً وديانةً باطلةً، وأصبحت بين يديه كرة من الثلج سرعان ما أجبرتها شمس الحقيقة على الذوبان، إن الهدف الذي توخاه الشيخ من خلال هذا البحث الخاص بالبابية وعلاقتها بالإسلام هو تبصير المثقفين في الشرق والغرب على السواء بحقيقة البابية وأهدافها واستغلال البعض لها، وقد أثبت الشيخ أنها ملة أخرى تغاير دين الإسلام وتخرج عليه، وتخالف جميع الأديان السماوية.
لقد شاء الله جل في علاه أن يفك أسر هذا العمل العلمي الرائع وأن يعود فكر الشيخ بعد ما يزيد على سبعين عامًا، يعود من غربته بذات توهجه الأول، ولنفس الأهداف والغايات، في وقت علا فيه صوت خصوم الأديان، وأصبح الخوف من الإسلام -دين السلام- «أيديولوجيا جديدة» عند صانعي القرار في كثير من بلاد الغرب والشرق، ولعودة الكتاب إلى وطنه ولغته قصة تروى في كلمات: منذ عامين تقريبًا عُقدت في مكتبة الإسكندرية جلسات عمل استمرت يومين حول موضوعي «الجهاد والردة» حضرها وحاضر فيها الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية مع نخبة من أعلام الفكر الإسلامي من مصر وخارجها بدعوة من الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وكان الحوار عميقًا والنقاش هادفًا والنتائج خطوات تعاون مثمر بين دار الإفتاء المصرية ومكتبة الإسكندرية، وفجأة قفز إلى ذهني الإمام عبد الرحمن تاج وكتابه الرائع الضائع، وقلت: إن ترجمته تمثل أملا، وتحتل أولوية في عصر للفتنة فيه ألف باب في مقدمتها باب «البابية»، وساعتها قال الأستاذ الدكتور علي جمعة: عليك بالكتاب وعلينا ترجمته ونشره، وها هو كتاب «البابية والإسلام» يطل على القارئ العربي لأول مرة في ترجمة دقيقة وبأسلوب عربي رصين، يأتي في موعده، ويلبي حاجة حقيقية، ولعله يكون بداية لسلسة تترجم أعمالا لأعلام كبار من رجالات الإسلام لا تزال طي النسيان في اللغات الإيطالية والألمانية والروسية والإنجليزية والفرنسية.
إنه أمل، هذه إرهاصاته، وما ذلك على الله بعزيز.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
محمد كمال الدين إمام
أستاذ بكلية الحقوق
جامعة الإسكندرية
تصفح الكتاب
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa